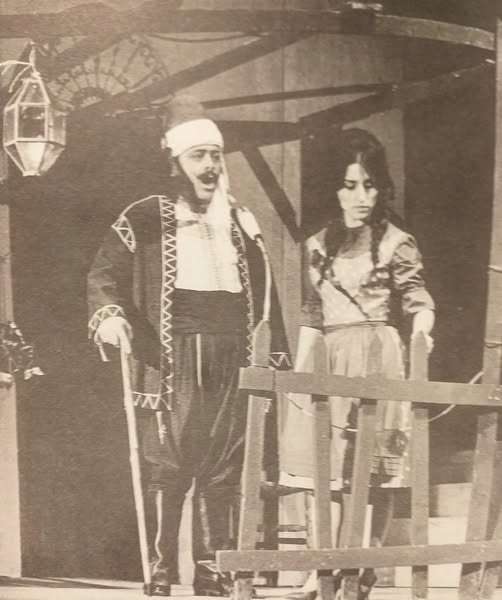
كنت قد نشرت في ملحق النهار، السبت 22 آب 1998، مقالة عن مفهوم الباب في الأغنية الرحبانيّة، أستعير مقدّمتها في هذه التتمّة عن صورة الباب، ولكن في المسرح الرحبانيّ من خلال ثمانية عشر عملًا، بدءًا من عام 1960 إلى 1975، ما عدا واحدة هي مسرحيّة بترا التي عُرضت سنة 1977.
"في وقت تفتح فيه الأبواب على كلّ الاحتمالات في هذا البلد المحكوم بأقداره، تأتي الكلمة من مكان آخر، من المكان الرحبانيّ – الفيروزيّ، حيث كلّ كلمة مفتاح لباب، وكلّ باب يفتح على آفاق جديدة، ووراء كلّ باب حكاية، وعلى كلّ عتبة وجه. قد تفتح الكلمة "باب الضوء"، وقد تغلق الكلمة الأبواب السبعة وتضع الرصد على أقفالها.
في هذا الزمن، حيث تلعب العواصف بالأبواب، وتتحكّم العواطف بالمفاتيح، وحيث الكلمة هي المفتاح السحريّ لمغائر اللصوص، تعالوا نلعب لعبة الكلمات، ونذهب إلى "باب" الكلمة" أو إلى كلمة "الباب"، ونقرع لعلّ أحدًا يفتح لنا. تعالوا نبتعد عن أبواب القصور، وكراسي الحكّام، ومفاتيح الخزائن، ونرحل إلى الأغنية، إلى الأغنية الرحبانيّة تحديدًا.
بين الداخل والخارج، يقف الباب ليكون إمّا حاجزًا وسدًّا منيعًا في وجه من يريد اقتحام حرمة الداخل، وإمّا ليكون مفتوحًا لمن يريد الدخول مسالمًا وضيفًا مكرّمًا. والعتبة التي ورد ذكرها كثيرًا في الأغنية الرحبانيّة هي هذا الحدّ الفاصل. وكم مرّة وقفت فيروز على العتبة، فلا هي قادرة على التفلّت من الداخل بتقاليده وموروثاته ورموزه، ولا هي تمتنع عن الرغبة في الانطلاق إلى الخارج بكلّ ما فيه من رحابة وتحرّر وتواصل مع الآخر.
هذا الباب، مثل التسميات المرافقة له: البوّابة، العتبة، والشبّاك أيضًا، هذا الباب، نقول، هو الوسيلة الوحيدة للقاء، للالتقاء، للرقيّ. وهو، في هذا الإطار، لا يصل الإنسان بالإنسان فقط، بل كان عليه في الأغنية الرحبانيّة أن يحمل الإنسان إلى الخارج بما فيه من عناصر طبيعيّة، أو أن يحمل هذه العناصر إلى الإنسان المطمئنّ في الداخل."
أمّا في هذه القراءة الحديثة الموزّعة على حلقات، فأقوم بمحاولة لالتقاط مفاهيم الباب كما هي في الفكر الرحباني اللصيق بجوّ القرية أوّلًا حيث البيوت المتلاصقة والأبواب المشرّعة، والمرتبط ثانيًا بالوطن الذي كان بوّابة بين الشرق والغرب. أمّا اختيار العنوان "بواب العتيقة" – وهو ليس من مسرحيّة – فيعود أوّلًا إلى التصاق صفة العتق بالأبواب الرحبانيّة، وثانيًا إلى أنّ أغنية "خدني ازرعني بأرض لبنان" التي أوحت بهذه القراءة للباب في الفكر الرحبانيّ، تحمل خلاصة النظرة إليه كرمز للأمان والارتباط والتواصل والعودة إلى البيت/ الوطن: بواب العتيقة عم تلوحلي (رمز القدم والتاريخ والأجداد)، وعيون ع شبابيك تشرحلي صحاب عم تقول نحنا صحاب (رمز الأجيال الجديدة والعيون البريئة التي تعد بغد من الصداقة)، خدني ازرعني بأرض لبنان/ بالبيت يللي ناطر التلّة/ إفتح الباب وبوّس الحيطان/ وإركع تحت أحلى سما وصلّي (الزرع والارتباط بالتراب، حراسة الأرض، العودة إلى الجذور، العاطفة العائليّة والوطنيّة، الإيمان والصلاة).
في الجزء الأوّل من هذه القراءة صورة الباب في أربع مسرحيّات: "موسم العزّ"، و"حكاية الإسوارة" و"جسر القمر"، و"الليل والقنديل".

1- موسم العزّ (1960)
مع بداية المسرحيّة تغنّي بطلتها نجلا (صباح): "تنهّد يا قلبي ودقّ ع باب الحلو/ بلكي بيفتحلك وهيك منسألو"، وهكذا يبدو الباب المفتوح صلة وصل بين العاشقين. ثمّ تظهر "الطاقة" أي النافذة الصغيرة كبديل عن الباب في الأغنية نفسها وهي بعنوان "يا إمّي طلّ من الطاقة": "يا إمّي طلّ من الطاقة/ وعليي دلّ من الطاقة/ شلحلي فلّ من الطاقة/ وغمزني وفلّ من الطاقة". كأنّ الباب للعلانية والوضوح بينما الطاقة أو النافذة فللستر والتلميح، ومن في الداخل يرى ولا يُرى بوضوح. ثمّ يغنّي شاهين (وديع الصافي) ويقول: "بوّابة اللي كلّها شمس ودفا/ يا ريتني يا ريتني ناطورها". هنا ترتبط البوّابة وهي أكبر من الباب وأوسع بالشمس والدفء كدليل على الانفتاح على الدنيا والناس والطبيعة، ولذلك تحتاج إلى حماية وناطور. وبعده يدعو مرهج القلاعي (رامز كلنك) نجلا التي يعشقها كي ترحل معه فيقول: لولا بتجي وبترافقي مرهج/ والهوا متلج/ والدني ضبابه/ وع كعب شي غابه/ بيت وجنينة وبوّابة". فكأن المتنافسَين على نجلا يعدانها ببوابّة لبيت يضمن لها الأمن والحماية.
وحين يقرّر شاهين بناء بيت لعروسه يقول: "بدنا نعمّر شي دارة/ يرتاح القلب بفيّتها/ وشي بنيّة تعقد زنّارا/ تقعد تغزل ع عتبتها". والعتبة هنا رمز للباب ودليل الأمان حين تجلس الصبيّة عليها، محميّة بالبيت وعلى تواصل مع الخارج في الوقت نفسه. ويتابع شاهين في أغنية "عمّر يا معلّم العمار" مخاطبًا البنّاء: "دبّرنا قبل تشارين/ بشي أوضة وعليّة ودار/ يكونوا شبابيكن حلوين"، وهكذا يغيب الباب فيحضر الشبّاك، وتجتمع الجماليّة مع النفعيّة، فلا يكفي أن يكون الشبّاك متينًا ومانعًا للبرد، بل يجب أن يكون جميلًا في تصميمه مع أحواض للزهور تتقدّمه.
صحيح أنّ الباب يغيب عن الفصل الثاني من المسرحيّة لكنّ دلالاته حاضرة في القنطرة والشبّاك والطاقة والدرج والسطح. ففي عرس نجلا وشاهين، تزغرد إحدى النساء قائلة: "آويها وزهورنا ع شبابيك دارنا حنيت/ والسعد وافى وقناطر بيتنا تعلّت". وحين يعجز أهل العريس عن رفع المحدلة تعاتبها نجلا وتقول: "بدّك روح مكسورة الخاطر/ لا زينة ولا تعيّد قناطر". لكنّ مرهج لا يقبل أن تذهب نجلا مع عريسها بلا رقص وأغنيات، فيرفع المحدلة بالنيابة عن أهل العريس وهو يقول: "شو ناطرة قناطر العم تعلا/ شو ناطرة؟ مش عرسها لنجلا؟". وهكذا تتمّ الفرحة وتغنّي الصبايا: "تعب الحكي وانزرع الهنا/ ع دراج وسطوح ضيعتنا"، ويغنّي الشبّان: "كِتر الحلا والحبق اغتنى/ بحواض وطواق ضيعتنا".

حكاية الإسوارة سهرة تلفزيونيّة من فصل واحد، عرضها تلفزيون لبنان والمشرق في مناسبة افتتاح المحطّة. تغنّي فيها عليا (فيروز) "بيتك يا ستّي الختيارة" وفيها: "عِتق الباب وهالحيطان". وتقول الختيارة (عليا نمري): "من زمان كنت ناطرة ع باب"، ويأتي صوت الختيار من ذاكرة العجوز متحدّثًا عن ولديه: "خلّيهن يروّجوا صوب البواب الناطرينن عليا رفقاتن". وهكذا يرتبط الباب بالزمن (العِتق) والانتظار والأمل. كأنّ الوقوف على الباب هو الخطوة الأولى لمواجهة العالم والناس وتغيّرات الزمن.
ويحضر الشبّاك أيضًا كرمز للتواصل مع الخارج، حين تقول سميرة (سميرة بعقليني) لسبع (فيلمون وهبه): "التنوضر ع الناس ممنوع. بكره بفرجيك. بدّي سكّر الشبّاك" (رفض اقتحام الخصوصيّة). ويجيبها سبع متحدّيًا: "سكّريه. شبابيك الله مفتوحة".

3- جسر القمر (1962)
في هذه المسرحيّة يتجدّد مفهوم الباب ببعده التواصليّ مع الخارج. ففي أغنية "هدّوني" الي يؤدّيها الشيخ (نصري شمس الدين) نسمع: "كانت عم تغزل ع الباب وتليعب صبيعا" فنرى امرأة تبحث عن الضوء (قبل عصر الكهرباء) لتحسن غزل الصوف فتجلس على عتبة الباب، كما نرى أصابعها وهي تلاعب المغزل. وتتابع الأغنية قائلة: "ولمن قالتلي شو باك واقف بخيال الشبّاك"، فنرى العاشق المختبئ خلف النافذة يتلصّص على الحبيبة. ثم نسمع: "ع بوّابتها المخضّرة قلبي رايح جايي" ونرى من جديد ارتباط البوّابة بالجمال واللون الأخضر من نباتات معرّشة عليه كالياسمين مثلًا، وكذلك بالتواصل مع الحبيبة.
أمّا صبيّة جسر القمر المسحورة (فيروز) فتغنّي: نيّال اللي بيرجع عشيّة/ وع كلّ البواب بيتلاقى بصحاب" فنرى في الصورة نظرة الأخوين رحباني للقرية التي لا غريب فيها بل أهل وجيران ينتظرون على الأبواب رؤية العائدين من أعمالهم. ويعود الباب ليظهر في قول "جميلة" (إلهام الرحباني): "رح آخد الجرّة/ وحطّها برّا/ بالفي حدّ الباب/ جارة الياسمينة"، وذلك طلبًا لبرودة المياه في جرار الفخار التي ترشح. ثم حين تقول الصبيّة: "ع كعب الجسر فيه كنز/ والكنز ع بابو حِرز/ محروس بكلمة سرّ": هنا الباب مرصود وفي فك الرصد عنه خلاص الصبيّة من السحر الذي يأسرها. ويتجدّد ارتباط الباب بالانتظار حين تغّني الصبيّة (فيروز) في "سنة عن سنة": ونطرتك على بابي بليلة العيد/ مرقوا كل صحابي ووحدك البعيد" ليجتمع الأمل والخيبة في مشهد واحد من بضع كلمات.
وقد يرتبط الباب بالذل والتسوّل كما في قول سبع (فيلمون وهبه) لمخّول (منصور الرحباني): "رح بتضلّ تزقّ كياس/ وتعتّل ع بواب الناس"، لكن سرعان ما يعود الباب والشبّاك مصدرَي فرح وحياة "وبوابنا مشرّعة/ ودراجنا خضرا" و"نفّض جناحاتو ع شبّاك الدار" و"جسر الشبابيك المفتوحة/ ع جناين مخضّرة شلوحها".

صحيح أنّ المكان في المسرحيّة هو خيمة "منتورة" (فيروز) بائعة القناديل، لكن أصحاب البيوت يقصدونها ليشتروا قناديل تطرد العتمة من البيوت والقلوب وساحات السهر: "بدنا نضوّي بيوت ل إلنا... نعلّقهن (القناديل) بالعرايش قدّام الشعريّات/ وقبال الورد العايش/ ع بواب السهريّات". وعند منتورة قناديل مختلفة الأنواع منها ما هو خاصّ بالباب :"وعنّا قناديل/ للريح التلجيّة/ للمشي بالضبابة/ ولقدّام البوّابة". ولأنّ الباب للحماية، يجب أن يكون قنديله مساعدًا في ذلك فيسأل أحد الشراة: "فيه عندك قنديل/ يتعلّق ع الباب/ ويبقى يردّ عنّي هجمات الدياب؟". ولأنّ الليل البلا قمر في حاجة للقنديل تستهدي به الحبيبة على بيت الحبيب تغنّي منتورة: "والدنيه غافلة/ والقمر غاب/ بتقشعني واصلِه/ عم دقّ الباب".
حين يلجأ الشرير "هولو" (جوزف عازار) إلى خيمة منتورة وهي لا تعرفه، تولد الأسئلة والرغبة في معرفة حكاية هذا المقيم في الوعر مع صديقه خاطر (وليم حسواني)، فتسأل "نصري الحارس" (نصري شمس الدين) عنه: فيه ليله كنّا بسهريه/ وسمعنا دعسه قويّة/ صوت دياب/ هواش كلاب/ وشفنا هَولو ع هالباب". فالباب إذًا الذي غالبًا ما يحمل الحبّ والشوق إلى الاحتكاك بالعالم الخارجيّ قد يصير مدخلًا للخوف والشرّ كما في حالة هولو. ولكن سرعان ما تعود للباب براءته وسرّ الدهشة فيه حين يغنّي الشباب لهدى (هدى حدّاد): حاجة تتعب قلبا/ وين بدّا تتخبّا/ الصبيّه من درب الحب/ ناطرها ع باب البيت". ويعود الباب ليرتبط بالحبّ والفرح في أغنية منتورة: "قالولي كتير قالولي وفتحولي بواب/ وياما الجيران حكيولي/ وقلبي ما تاب"، ثمّ تتابع: "ع باب البيت عم غنّي/ ان كنّك حبّيت طمّني". ويليها نصري وهو يتذكّر حبًّا قديمًا: " ومعرّش الزنبق على سورا/ وتضلّ تتمخطر ع باب الدار".




.jpg)








