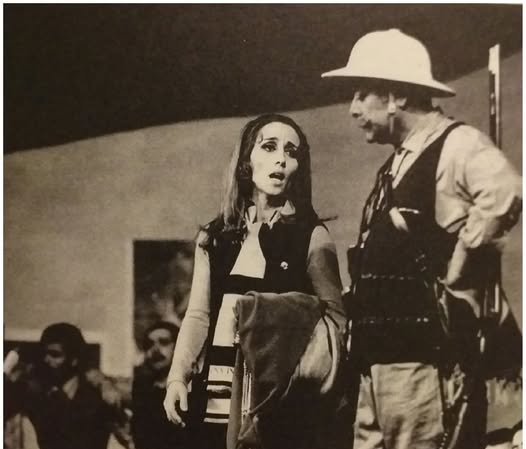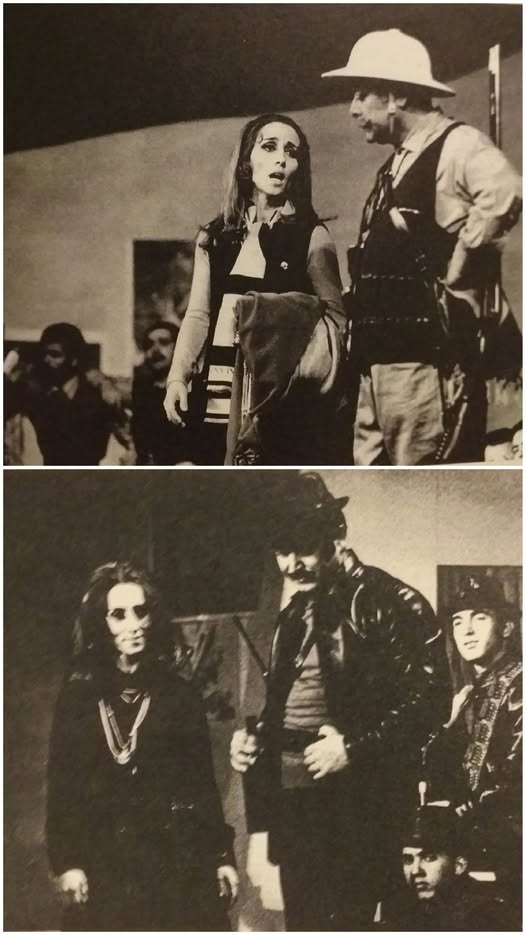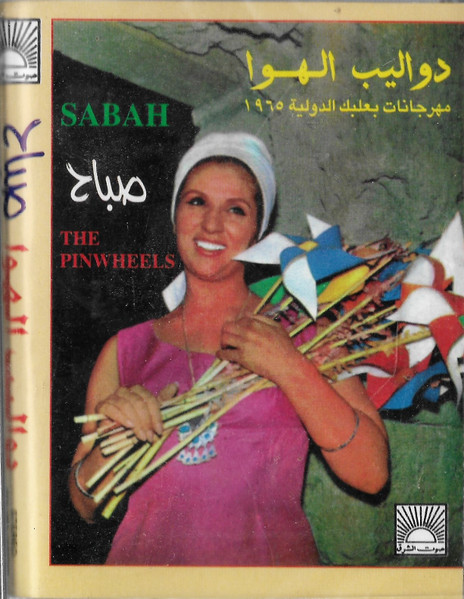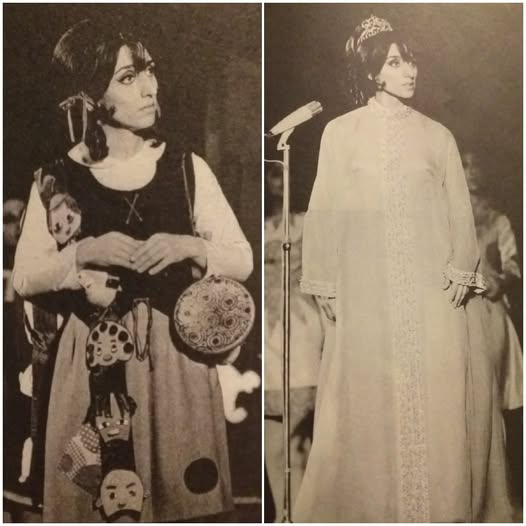اللايدي غوديفا Lady Godiva شخصيّة إنكليزيّة حقيقيّة عاشت في القرن الحادي عشر، وعُرفت بحبّها لأعمال الخير ومساعدة المحتاجين. وكان زوجها ليوفريك، أحد أقوى النبلاء الإنكليز في تلك المرحلة لكنّه على عكسها كان يفرض ضرائب باهظة على الناس. وكانت هي تلحّ عليه كي يخفّف الأعباء عن شعبه. ولكي يرتاح من إصرارها طلب منها أن تخرج عارية على حصانها وتعبر شوارع المدينة كي ينفّذ طلبها. وهذا ما فعلته. فوافق على تخفيض الضرائب.
من وطن مستقلّ إلى شعب مستقيل

منذ ستّين عامًا، خصّت مجلّة "الحكمة"، في السنة الثالثة عشرة على تأسيسها، الرئيس الشيخ بشارة الخوري بعدد خاصّ. وهذه المجلّة الثقافيّة الشهريّة التي كانت تصدرها مطرانيّة بيروت للطائفة المارونيّة، احتفلت بذكرى الرئيس الأوّل للبنان ما بعد الاستقلال بعددٍ دسم المواد لشهرَي كانون الثاني وشباط من سنة 1965، كتبت فيه نخبة من أهل السياسة والقلم. وكان ذلك في عهد الرئيس فؤاد شهاب (رجل الدولة والإدارة)، والبطريرك بولس بطرس المعوشي (أوّل بطريرك مارونيّ يحصل على لقب كاردينال)، وراعي أبرشية بيروت للموارنة اغناطيوس زيادة (آخر مطارنة بيروت المستقيمي الرأي).
كان للمجلّة عهدذاك دور ثقاقيّ ذو شأن، تنشر لشعراء وأدباء ومفكّرين صنعوا مجد الأدب اللبنانيّ، ثمّ بدأ نجمها بالأفول بالتزامن مع تراجع الدور التربويّ الرائد لمدارس الحكمة التابعة لأبرشيّة بيروت المارونيّة، إلى أن احتجبت المجلّة نهائيًّا.
في العدد المذكور نصوص ومخطوطات وخطب ورسائل وصور تتعلّق بالمحتفى به. ولافت جدًّا أنّ أكثر المشاركين وعددهم ستة وثمانون من المسيحيّين. وإذا علمنا أنّ رئيس المجلّة ومدير تحريرها هو الدكتور جميل جبر، وهو رجل علم وأدب، استنتجنا أنّه لا بدّ سعى لدعوة أكبر عدد من أهل السياسة والأدب للمشاركة في عدد خاصّ بالرئيس الأوّل لجمهوريّة لبنان ما بعد الاستقلال. فلماذا إذًا هذا العدد المتواضع لغير المسيحيّين؟ وهل كان بشارة الخوري في تلك المرحلة محسوبًا على المسيحيّين فقط، وعلى الموارنة تحديدًا وقد اعتبروه رئيسًا للوطن الذي سعوا إليه؟ وهل اعتذرت أقلام غير مسيحيّة، إذا جاز التعبير، عن عدم المشاركة، علمًا أنّ تاريخ المجلة يشهد على غناها بمواد من سائر المدارس الفكريّة والدينيّة والمذهبيّة؟ وهل يثبت هذا النموذج التاريخيّ على أنّ صيغة لبنان الميثاقيّة، والرئيس الخوري أحد ركنيها، لم تشمل الشعب كلّه، أو هي في تلك المرحلة بالذات، وبعد ثورة 1958، كانت قيد الدرس؟ وفي المقابل، هل كانت خمسينيّات وستينيّات القرن العشرين العهد الثقافيّ الذهبيّ للمسيحيّين الذين أسّسوا الصحف والمجلّات والمسارح فكانت لهم السيطرة في مجالات الفنّ والأدب والفكر؟
يثير الاطّلاع على فهرس الأسماء في هذا العدد من المجلّة المحتجبة عن الصدور حسرة على اللغة العربية. فالأسماء الواردة فيها مشهود لها بسعة المعرفة وعمق الثقافة والتمكّن من اللغة العربيّة، على عكس ما هي الحال عليه اليوم عند السياسيّين والإعلاميّين. وهذا ما فضحه رحيل الإعلاميّ والمربي بسّام برّاك الذي ارتبط رثاؤه برثاء اللغة العربيّة وكأنّه آخر المحافظين عليها.
فمن يمكنه التشكيك في ثقافة كلٍّ من الرئيسين شارل حلو وفؤاد شهاب، أو البطريرك المعوشي، بالعربية والفرنسية، وآخرين أجريت معهم مقابلات أو أدلوا بشهادات وجلّهم من الحقوقيّين والمربّين والصحافيّين. في المقابل، سيجد أحدنا صعوبة اليوم في إيجاد بضعةٍ من حملة الأقلام لا يستعينون بمن يدبّج لهم مقالاتهم أو خطبهم. طبعًا ليس في الأمر حرج أن يستعين المرء بمدقّق لغويّ أو محرّر لخطبة أو مقالة أو حتّى كتاب. ولكن ما استدعى منّي الاهتمام بهذا العدد من أرشيف مجلّة الحكمة هو أنّ العدد الأكبر من المساهمين في مواد المجلّة يغري القارئ بالتفتيش عن مقالته أو حديثه، لا من أجل السياسة بل من أجل التمتّع بالصياغة واللغة.
كانت الأنواع الأدبيّة في ذاك الزمن من شعر وخطابة ونثر وزجل في أوج مجدها، حتّى مرافعات المحامين كانت تُنتظر لما فيها من بلاغة وسبك متين، ومقالات الصحافيّين تُقتطع من الجرائد والمجلّات ويُحتفظ بها بسبب رؤيويّتها وعمقها ولغتها. وكانت مداخلات النوّاب في الجلسات العلنيّة فصيحة بليغة تعلي شأن الخطابة والتخاطب.
بعد ستّين عامًا على ذاك الاحتفاء برجل الاستقلال من خلال كتابات أدبيّة راقية المضمون والأسلوب، لا يمكنني وأنا أقلّب صفحات المجلّة سوى التساؤل: هل يجوز لوطن لا لغة له أن يحتفل بالاستقلال؟ وكيف حال اللغة العربيّة في مجتمع مسيحيّ كان إلى الأمس يتباهى بأنّه قاوم التتريك؟ وهل الهجمة الحاليّة على البودكاست بالمحكيّة اللبنانيّة تهرّب من الكتابة بالفصحى أو التكلّم بها؟ أسئلة أعرف، وتعرفون، أجوبتها، لكنّي، مثل أكثركم من المهتمّين باللغة ومستوى أهل الصحافة والسياسة، أكتفي بالسؤال كي لا يصفعني الجواب.
*أسماء المشاركات والمشاركين باللغة العربيّة بحسب ترتيب مقالاتهم في العدد المذكور: الرئيس شارل حلو، الدكتور عبدالله اليافي، الوزير إدوار حنين، الدكتور فؤاد عمّون، محمّد شقير، سليم باسيلا، الوزير فيليب تقلا، جوزف باسيلا، لحد خاطر، بدري المعوشي، وجدي الملّاط، أنطوان قازان، ميشال خوري (نجل الرئيس بشارة الخوري)، كامل مروّة، عبدالله لحّود، خليل أبو جودة، يوسف يزبك، البطريرك المعوشي، الرئيس فؤاد شهاب، غسّان تويني، علياء الصلح، جميل جبر، رياض حنين، الياس عبّود نجم، إملي فارس، فوزي سابا، فؤاد نفّاع، ألبرت الريحاني، إميل الكك، فؤاد مطر، رشدي المعلوف، عارف الغريب، حسيب عبد الساتر
https://www.cafein.press/post/mn-otn-mstkl-al-shaab-mstkyl